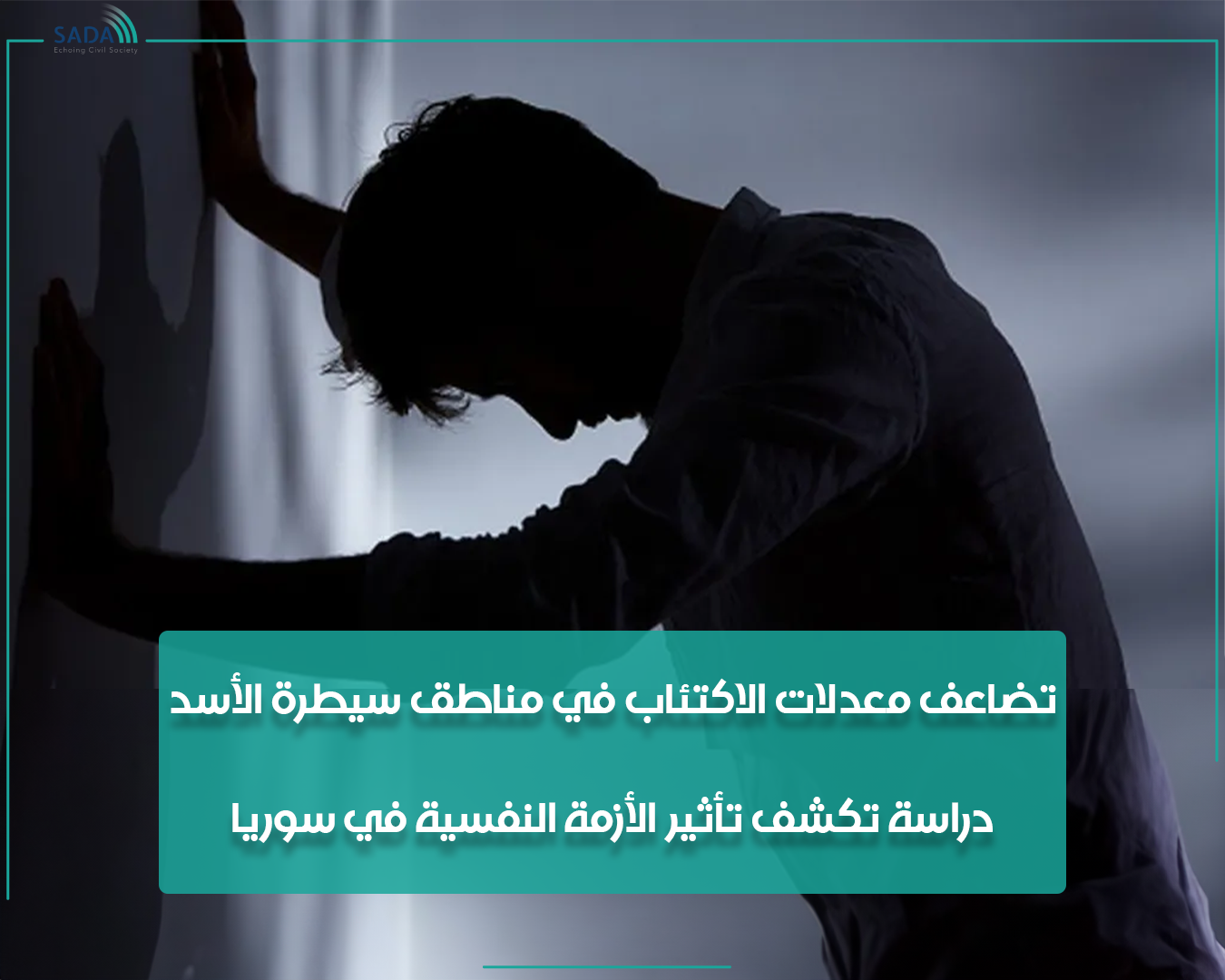مصير التسوية السياسية العربية – الإسرائيلية بعد أربعين عاما على حرب 1967

مقدمة
يثير الاستعداد الذي يظهره النظام السوري للانخراط في مفاوضات بشأن التسوية السياسية مع إسرائيل من دون
شروط مسبقة، بعد إصراره الطويل على البدء من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات السابقة، فضلا عن التصريحات التي أطلقتها عدة شخصيات إسرائيلية، ولا تزال تطلقها، ومنها مسؤولون في حكومة إيهود أولمرت عن ضرورة امتحان إرادة سورية في التسوية السياسية والدخول معها في مفاوضات، مخاوف أطراف عربية عديدة، منها: من يخشى أن يشكل ذلك تشجيعاً لدمشق على الاستمرار في سياستها الانفرادية وتحالفاتها الإيرانية؛ من يخاف من أن يكون فتح مسار التفاوض السوري – الإسرائيلي اليوم وسيلة للتغطية على التعطيل الطويل الذي يعاني جراءه المسار الفلسطيني – الإسرائيلي، وإضعاف فرص إطلاق هذا المسار في المستقبل القريب إن لم يهدد أمل التوصل إلى تسوية معهم؛ من يعتقد أن المبادرة السورية الخاصة ربما كانت تهدف إلى قطع الطريق على المبادرة العربية التي تعطي المسألة الفلسطينية الأولوية. وتأتي زيارة إبراهيم سليمان رجل الأعمال السوري الأميركي لتل أبيب، ولقاؤه الكثير من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، بعد أن نشرت الصحافة العبرية والدولية نص اتفاق المبادئ الذي كان توصل إليه مع زميله الإسرائيلي ألون ليئيل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية ليضفيا بعض المشروعية على هذه المخاوف، مؤكدَيْن في الوقت نفسه الأهمية الكبيرة التي تعطيها دمشق لقضية استئناف مفاوضات التسوية السياسية مع إسرائيل لأسباب يتعلق بعضها باستراتيجيتها الدولية، وبعضها الآخر بوضع النظام الإقليمي وتحديد مستقبله داخل سورية نفسها.( 1) ومما يعزز هذا الاعتقاد التحسن الملحوظ في، العلاقات الأميركية – السورية الذي ظهر في مؤتمر شرم الشيخ بشأن العراق في الثالث من أيار/مايو 2007 والذي أثار أيضاً مخاوف الإيرانيين، على الرغم من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية وليد المعلم ونظيرته الأميركية كوندوليزا رايس في 3 أيار/مايو 2007 في شرم الشيخ لن يكون له انعكاس على العلاقات بين سورية وإيران. والسؤال هو: هل هناك فرص حقيقية لتحقيق مثل هذا الاختراق في عملية السلام العربية – الإسرائيلية انطلاقا من سورية بعد أن توقفت تماماً بعد إخفاق مؤتمر جنيف في آذار/مارس 2000 الذي جمع بين الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في بادرة أخيرة لإنقاذ مشروع السلام والتوصل إلى اتفاق سوري – إسرائيلي ناجز، كان يبدو كأنه أصبح بحكم المضمون؟
في شروط التوصل
إلى تسوية سياسية
ليس هناك من يستطيع أن يرجّم بالغيب في موضوعات كهذه تدخل فيها عوامل متعددة، وطنية وإقليمية ودولية معاً. ويتسم سلوك الفاعلين فيها بحذر شديد، نظراً إلى تضارب المصالح وتداخل التحالفات وتعدد الرهانات المرتبطة بها، ويجري جزء كبير منها في إطار من السرية الشديدة وأحياناً المناورات السياسية. لكن يجب التمييز بداية بين الدخول في مفاوضات، حتى لو كانت جدية لا صورية، وبين فرص النجاح في التوصل إلى تسوية فعلية. وقد عرفت المنطقة تجارب عديدة لهذه المفاوضات، وبرزت إلى الوجود مسارات متعددة للتسوية مع إسرائيل لم تكن كلها مسارات جدية، ولم يقد أي منها حتى الآن، باستثناء اتفاق كامب ديفيد الإسرائيلي – المصري، إلى نتائج عملية. والسبب في ذلك أن فرص نجاح عملية التفاوض لا ترتبط، في الشرق الأوسط الراهن، بإرادة الأطراف المتفاوضة وحدها فحسب، بل أيضاً بعوامل متعددة أُخرى قد لا تقل أهمية عنها.، العامل الأول هو الوضع الدولي. فبقدر ما تشكل السيطرة على الشرق الأوسط موضوع رهان دولي، تمثل النزاعات والتسويات فيه جزءاً من مسألة أكبر تعنى بتقرير أو تأكيد الهيمنة الدولية أو تأكيدها. وأكبر مثال لذلك، الاستقطاب الذي حدث بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي خلال حقبة الحرب الباردة. فهذا الاستقطاب لم يغلق الطريق على أي تسوية سياسية فحسب، بل أيضاً على فكرة المفاوضات نفسها واحتمال إيجاد حل للصراع من خلالها، لكنه فرض على طرفي الصراع الشرق الأوسطي الالتحاق باستراتيجيات القوى الكبرى المتصارعة. ولم يكن من الممكن التوصل في ثمانينيات القرن الماضي إلى اتفاق كامب ديفيد، الذي أنهى النزاع بين مصر وإسرائيل، إلاّ بقدر ما غيرت مصر في توجهاتها الكبرى. فجاءت اتفاقية السلام مع إسرائيل في سنة 1979 جزء من عملية أكبر هي الحفاظ على نظام الهيمنة الغربية على الشرق الأوسط، أي على المنطقة التي تشكل خزانا استثنائيا للنفط الذي تحتاج إليه الدول الصناعية. والسؤال على هذا المستوى هو: هل الوضع الدولي، وتوازن القوى، وحاجات الدول الكبرى ذات النفوذ القوي في المنطقة، ملائمة اليوم لإطلاق عملية التفاوض بين الأطراف وتشجيعها على التوصل إلى تسوية مقبولة، أم لا؟ وفي هذا المجال يشكل تحليل الاستراتيجيا الأميركية الدولية، والشرق الأوسطية خاصة، عنصراً أساسياً في أي تقدير لفرص التوصل إلى تسوية سورية – إسرائيلية. العامل الثاني هو الوضع الإقليمي. وهو ما يتسم في الوقت الحاضر بسيطرة أربع أزمات رئيسية: أزمة الاحتلال الأميركي للعراق؛ أزمة تخصيب اليورانيوم والسيطرة على التقنية النووية في إيران؛ الأزمة السياسية اللبنانية المرتبطة بمسألة المحكمة الدولية ولجنة التحقيق في مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري؛ الأزمة الفلسطينية النابعة من تفاقم عواقب استراتيجيا الحصار التي فرضت على الشعب الفلسطيني بعد نجاح “حماس” في الانتخابات التشريعية ورفض المجموعة الغربية وإسرائيل التعامل معها. ومن الضروري معاينة ما يحدث أيضاً، على خلفية هذه الأزمات جميعاً وبموازاتها، من استقطاب بين دول الممانعة المعادية لأميركا، ودول الاعتدال المشجعة على التوصل إلى تسويات جزئية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. والسؤال هو: ما هو الأثر المحتمل لهذا الاستقطاب والتصادم بين سياسات ما يسمى دول الاعتدال وسياسات دول الممانعة، في فرص التوصل إلى تسوية أو التشجيع عليها بين سورية وإسرائيل؟ العامل الثالث هو وضع الحكومتين السورية والإسرائيلية المنخرطتين في النزاع أو الساعيتين للتسوية، وهامش مناورة كل منهما الداخلية، وما يمكن أن تمثله التسوية السياسية من مخاطر عليهما من جهة، وكذلك من رصيد يساهم في تعزيز شرعيتيهما عند الرأي العام ويساعدهما في مواجهة التحديات التي تتعرضان لها وحل المشكلات الوطنية الأُخرى العالقة أو المتعثرة، الاقتصادية منها والسياسية والأمنية، من جهة أُخرى. هذا يعني أن علينا ألاّ نقصر تحليلنا لعملية التفاوض على أبعادها التقنية أو حتى السياسية، ولا بد من النظر إليها ضمن إطار أشمل، أعني إطار الاستراتيجيات الشاملة التي تبلورها وتتبناها الأطراف المتعددة المنخرطة فيها
من حرب العراق الأولى
إلى مؤتمر مدريد للسلام
لم تنطلق عملية المفاوضات العربية – الإسرائيلية جديا إلا عندما أطلقت الولايات المتحدة مدعومة بأوروبا وروسيا مؤتمر مدريد للسلام في سنة 1991 . وجاء هذا المؤتمر لتمتين أواصر التحالف بين الغرب الأطلسي والدول العربية وتغطية انخراط هذه الدول الأخيرة في الحرب الأولى ضد العراق. وكان التوصل إلى تسوية، أو على الأقل إلى إطلاق مساراتها المتعددة، جزءاً من سياسة دعم النظام الإقليمي الناشئ عن الانتصار على نظام صدام حسين، بعد أن أنجز هذا النظام نفسه في فترة سابقة عملية تحجيم إيران، خلال الحرب الدموية التي دامت أكثر من ثمانية أعوام، ودرء مخاطر تمدد الثورة الإسلامية أو تصديرها. وقد عززت مفاوضات السلام التي شجعتها واشنطن ودول الأطلسي عامة بين إسرائيل والعرب التفاهم العربي – الأطلسي، وسعت لتعزيزه وترسيخه بوضع أهداف مشتركة والتقريب بين مصالح مختلف الأطراف، حرصاً على دعم استقرار النظام الإقليمي الناشئ ودعم قدراته. وكان لمشاركة سورية في الحرب على العراق دور رئيسي في تحقيق المناخ الجديد وتشجيع واشنطن على الانخراط في عملية التفاوض بين العرب والإسرائيليين.
لكن المفاوضات التي انطلقت من مؤتمر مدريد لم تستمر طويلا بعد أن أنجزت المهمة التي أوكلت إليها، أعني تفعيل التحالف العربي – الأطلسي ضد العراق، وإضفاء نوع من الشرعية على الحرب التي شنت على البلد الشقيق. فلم تمض أعوام قليلة حتى انهارت، وحل محل السعي نحو السلام منذ سنة 1996 تراشق بالاتهامات بين البلاد العربية وإسرائيل. وأخفقت المحاولات كلها التي بذلت بعد اغتيال يتسحاق رابين، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، لإعادة المفاوضات إلى مسارها. فبينما تمسكت سورية بمبدأ العودة إلى المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها، مؤكدة الوعود التي أعطيت لها بالانسحاب الكامل من الجولان، وهو ما أُطلق عليه وديعة رابين، أصرت إسرائيل، لقطع الطريق على استئناف المفاوضات والتدليل على عدم اهتمامها باستكمالها، على العودة إلى المفاوضات من دون شروط، أي من دون أي اعتبار لما تم التوصل إليه من تفاهمات. وهو ما كان يعكس زوال
الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق يستدعي لا محالة التخلي عن الجولان أو عن جزء كبير منه. واستقر الموقف الإسرائيلي على أن الاحتفاظ بالجولان يشكل مصلحة أكبر لإسرائيل من التوصل إلى اتفاق سلام مع بلد ليس لديه أي قدرة على استرجاعه بالقوة أو على شن الحرب. وعندما تغير الوضع وأصبح لدى الولايات المتحدة وإسرائيل حوافز جديدة ومصلحة في تغيير المناخ الإقليمي وتحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، لم يجد الرئيس بيل كلينتون صعوبة كبيرة في إيجاد صيغة تسمح باستئناف المفاوضات. وهو ما تحقق فعلاً في أواخر سنة 1999 عندما أعلن كلينتون – عقب انتهاء جولة وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت في المنطقة ولقائها الرئيس السوري حافظ الأسد – استئناف المفاوضات السورية – الإسرائيلية من النقطة التي توقفت عندها سنة 1996 . وكانت الإدارة الأميركية نجحت في فك عقدة استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها من خلال ترك هذا المصطلح غامضاً بما يتيح لكل طرف تفسيره بالطريقة التي تلائمه. وهكذا بينما حرص إيهود براك على التأكيد أنه لم يلتزم أي شروط لاستئناف المفاوضات، متجنباً الإشارة إلى موقف محدد من الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 ، التزمت سورية الصمت تجاه ما حصلت عليه من تعهدات من الطرف الإسرائيلي لقاء عودتها إلى طاولة المفاوضات. وليس من المستبعد أن يكون براك أعطى الإدارة الأميركية تعهداً شفويا بتنفيذ انسحاب من كامل الجولان مع تعديلات بسيطة فيما يتعلق بالحدود.
من الواضح أن استئناف المفاوضات عبّر، في هذه المرحلة، عن توافق مصالح مختلف الأطراف في الخروج من حالة الجمود. فقد أراد الأسد أن يكون إنجاز نوع من السلام مع إسرائيل يعيد الجولان إلى الوطن الأم، في إطار الانفتاح على أوروبا والغرب، مقدمة سعيدة لإعداد خلافة نجله بشار الأسد. أمّا حكومة براك فكان عليها أن تنفذعهدها الانتخابي الذي أكدته في الكنيست الجديد بالانسحاب من لبنان بحلول تموز/يوليو 2000 ، والخروج من حرب الاستنزاف التي فرضها عليها حزب الله في جنوبه. وهو ما لا يمكن أن يحدث إلاّ بمعاهدة سلام مع لبنان الذي يرفض ذلك من دون أن يتزامن مع معاهدة سلام مع سورية، أو بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من لبنان يحمل مخاطر أمنية كبيرة للدولة العبرية. كما أن إنجاز معاهدة على صعيد المسار السوري – اللبناني كان يعتبر لحكومة براك – أقل تعقيداً من إنجاز الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية التي سيضعف موقفها التفاوضي في مقابل تعزيز مكانة الحكومة الإسرائيلية بعد ظهورها بمظهر الراغب في السلام. وكان هذا سيقوي موقف إسرائيل السياسي على الصعيد الدولي ويدفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على الطرف الفلسطيني للقبول في النهاية بالتصور الإسرائيلي لقضايا الحل النهائي، وهو تصور قد يصعب على السلطة قبوله، لأنه يكرس واقع الاحتلال الاستيطاني ويتجاهل القضايا المحورية المتمثلة، على سبيل المثال، في القدس واللاجئين. وفي المقابل، كانت الإدارة الأميركية تدرك أن تحقيق مثل هذا السلام سيشكل عاملاً قويا في ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي ستصبح خاضعة كلياً تقريبا لنفوذها. وكان بيل كلينتون يتوق شخصياً إلى أن يختم فترة رئاسته، التي شابها كثير من الانتقادات بسبب سلوكه الشخصي، بعمل إنساني كبير يخلد اسمه.
انهيار الجولة الأولى
من محادثات السلام
كان لهذا التوافق بين جدولي الأعمال الأميركي والإسرائيلي دور كبير في تقدم المفاوضات من جهة، وفي إعطاء المفاوضات السورية – الإسرائيلية الأولوية على حساب المفاوضات الفلسطينية، من جهة أُخرى. وكادت المفاوضات تسفر فعلا عن تنفيذ مرحلة إعادة الانتشار الثالثة التي نصت عليها اتفاقيتا واي ريفر وشرم الشيخ، والتوصل إلى إطار اتفاق الحل النهائي، بل إنجاز الاتفاق الكامل للحل النهائي بين البلدين، لولا تردد حكومة براك في اللحظة الأخيرة، ولحسابات السياسة الداخلية الإسرائيلية وحدها. وهذا ما عبر عنه رفض الطرف الإسرائيلي تقديم تعهد واضح بالانسحاب إلى حدود 4 حزيران/يونيو والإصرار على الاحتفاظ بالشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرية، الذي يقع ضمن هذه الحدود في الطرف السوري، مع أن سورية أبدت مرونة كبيرة تجاه احتفاظ إسرائيل بمصادر مياه الأنهار التي تصب في هذه البحيرة، إضافة إلى إظهار استعدادها لإجراء تغييرات تؤدي إلى ترسيم خط الحدود مع الدولة العبرية بحيث يمر بين خط الحدود الدولية الذي حدده اتفاق 7 آذار/مارس 1923 بين فرنسا وبريطانيا، وبين خط 4 حزيران/يونيو 1967 الذي يحدد حدود سورية قبل حرب 5 حزيران/يونيو1967 . وقد أكد بعض التقارير الصحافية الإسرائيلية أن مطالب براك تجاوزت ذلك، وشملت الدعوة إلى إجراء200 متر، تضمن – تعديلات على خط 4 حزيران/يونيو نفسه وإزاحته عند بحيرة طبرية نحو الشرق بمسافة 100 للطرف الإسرائيلي، إضافة إلى ضم منطقة الحمة، السيطرة على بحيرة طبرية من جوانبها كافة وهكذا أنهى فشل القمة الأميركية – السورية (جنيف 26 آذار/مارس 2002 )، الحلقة الثانية من المفاوضات التي انطلقت على أساس مؤتمر مدريد الذي نص على مبدأ الأرض في مقابل السلام. وأعقب هذا الفشل استئناف مناخ النزاع والحرب، مع انسحاب أميركي واضح من العملية، وتراجع الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى حلول متفق عليها لمصلحة الحلول التصفوية وفرض الإرادة بالقوة، الأمر الذي ستعبر عنه السياستان الإسرائيلية والأميركية في الأعوام التالية. فقد كانت النتيجة الأولى لانهيار المفاوضات استئناف الهجوم الإسرائيلي على لبنان وتدمير منشآته المدنية، واندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، ثم دعوة حكومات جامعة الدول العربية، عبر اجتماع
مجلس وزراء خارجيتها في بيروت أوائل آذار/مارس 2000 ، إلى إعادة النظر في عملية التطبيع مع إسرائيل، وفي
المشاركة في المفاوضات متعددة الأطراف، إضافة إلى تأكيد دعم الدول العربية المطلق للبنان في مقاومة الاحتلال
الإسرائيلي باعتبار ذلك دفاعاً مشروعاً عن النفس، والتشديد على رفض توطين اللاجئين خارج فلسطين، والدعوة
إلى ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان. لم يغير عقد قمة شرم الشيخ التي جمعت بين براك وعرفات، برعاية الرئيس المصري حسني مبارك، في استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وتغيير منحى الجمود السياسي والتوجه نحو سياسات المواجهة. كما لم تثن التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية، على صعيد القبول بمخطط إعادة الانتشار، الحكومة الإسرائيلية عن إرادتها في حسم الصراع بالطرق العسكرية ومن جانب واحد، بعيداً عن أي إطار للمفاوضات، سواء في لبنان أو في فلسطين. وفي المقابل، فاقمت هذه القمة حدة الخلافات بين الدول العربية، بين مصر وسورية خاصة، بشأن موضوعي التطبيع والمفاوضات متعددة الأطراف. وأدى رفض مصر مطلب سورية وقف التطبيع وعدم المشاركة في المفاوضات متعددة الأطراف إلى إضعاف دور مصر في إطار جامعة الدول العربية، وتبني الأخيرة قرار دعم المقاومة اللبنانية الذي أثار انزعاج واشنطن وتل أبيب. وباختيار إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني من جانب واحد، زاد استهتارها بعملية السلام وما عادت تشعر بأنها معنية بالمفاوضات مع سورية، أو بالتوصل إلى اتفاق معها. كما أن انشغال إدارة كلينتون بالانتخابات الأميركية التالية، وسعي الديمقراطيين للتقرب من السياسة الإسرائيلية واللوبي الإسرائيلي لضمان نجاح المرشح الديمقراطي آل غور، عملا على تراجع الاهتمام الأميركي بأزمة الشرق الأوسط. أمّا الدول العربية فاتجهت إلى الاهتمام بمشكلاتها الداخلية المتزايدة. إلاّ إن الأمر الذي سيوجه الضربة الأخيرة إلى عملية السلام هو بلا شك تولي المحافظين الجدد سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية. أمّا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 التي أعقبت ذلك، فدفعت بواشنطن إلى تبني سياسة مناقضة تماماً للسياسة الأميركية – الغربية التي سادت منذ مؤتمر مدريد، أي سياسة السعي لتسوية سياسية في الشرق الأوسط. فقد دفعت واشنطن إلى تبني سياسة فرض الأمر الواقع على العرب بالقوة، والتقرب بشكل لم يسبق له مثيل من سياسات تل أبيب والرهان على التفاهم معها لحسم الأزمات الإقليمية، في فلسطين ولبنان وسورية والعراق وبقية الدول الأُخرى. وقد وضعت واشنطن هذه المقاربة العسكرية الجديدة في إطار استراتيجيا الحرب العالمية ضد الإرهاب، قبل أن تطلق مشاريع إصلاحها الديمقراطية، كي يتسنى لها إيجاد تغطية سياسية وشرعية لها. ومن الطبيعي أن يترافق تطبيق مثل هذه السياسة مع دعم غير مشروط لإسرائيل والمراهنة على قوتها وتعاونها على إنجاح الاستراتيجيا الجديدة التي تهدف إلى استعادة السيطرة على المنطقة العربية، الأمر الذي يعني القضاء، إذا أمكن، على قوى المقاومة التي وُسمت في فلسطين ولبنان وغيرهما من البلاد العربية بالإرهابية، وإجبار هذه الدول على القبول بإسرائيل كما هي، والاصطفاف وراء التحالف الأميركي – الإسرائيلي
من دون شروط. وقد دفع هذا إسرائيل أيضاً إلى الإمعان في سياسة التحدي والغطرسة وتوسيع رقعة الاستيطان والتفكير في إمكان تصفية القضية الفلسطينية والقضية السورية بالقوة، وعدم الاكتراث لدعوات السلام التي تطلقها دول عربية فقدت احترامها، وزادتها أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر انكشافاً سياسياً واستراتيجياً أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
ومع فقدان الحكومات العربية أي أمل بالضغط على إسرائيل لإعادتها إلى سياسة الحوار والتفاوض، وجدت نفسها مدفوعة على الرغم منها إلى القبول بالأمر الواقع والتعامل مع واشنطن وتل أبيب لتأمين شروط استمرار حياة نظمها السياسية والاقتصادية. واكتفت فيما يتعلق بقضايا الاحتلال بالتذكير في المحافل الدولية بضرورة استئناف مفاوضات السلام، ومطالبة أوروبا بصورة خاصة بموقف متميز من موقف الولايات المتحدة، أو باتخاذ مبادرات فعالة لإخراج المنطقة من حالة اليأس التي تعيش فيها.
الأزمة الإيرانية واحتمالات
استئناف المفاوضات العربية – الإسرائيلية
هناك عوامل عديدة تشير إلى إمكان انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية في المدى المنظور، ومن ثم المفاوضات السورية – الإسرائيلية. بل إن هذه المفاوضات بدأت فعلاً وإن كانت بأساليب مواربة وجانبية. من أهم هذه العوامل ما يتعلق بتطور الوضع الدولي. فالمنطقة تعيش اليوم حالة شبيهة في بعض جوانبها بالحالة التي كانت تعيشها في تسعينيات القرن الماضي والتي أدت إلى إطلاق مبادرة مؤتمر مدريد للسلام، أعني حاجة واشنطن الواضحة إلى تحشيد الدول العربية، والخليجية منها بصورة خاصة، في مواجهة الخطر الجديد الناجم عن تصاعد قدرات إيران العسكرية وتهديدها المحتمل لاستقرار النفوذ الغربي، والأميركي خاصة، في المنطقة. ومما يزيد في هذه الحاجة إدراك واشنطن خيبة الأمل العربية الكبيرة بسياستها الإقليمية، وانهيار استراتيجيتها الشرق الأوسطية، وفقدانها الخيارات في معالجة ما تواجهه من تحديات، سواء أكان ذلك في إيجاد مخرج من الورطة العراقية، أم في وقف عملية إنتاج طهران اليورانيوم المخصب الذي يهدد وجود اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، أم في تثبيت الوضع في لبنان أو في فلسطين.( 4) وثمة توافق عام بين المراقبين على أن المقاربة العسكرية للأزمة فشلت، وأن فتح الحوار، كما أشار إلى ذلك بشكل قوي تقرير بيكر – هاملتون، يمكن أن يشكل مقاربة أكثر نجاعة. كما أن هناك توافقاً في وجهات نظر المحللين لا يقل عن سابقه في أن الحكومات العربية ما عادت قادرة على السير خلف السياسة الأميركية وتحدي الرأي العام العربي من دون معالجة الصراع العربي – الإسرائيلي. وفي المقابل، تعتقد حكومات جامعة الدول العربية عامة أن هناك فرصة اليوم للتوصل إلى بعض النتائج الإيجابية، تكمن في استغلال الضعف الأميركي وحاجة واشنطن إلى مساعدة الدول العربية في لملمة الوضع المتدهور في المنطقة والمهدد للمصالح الأميركية الاستراتيجية. وانطلاقا من ذلك تداعت الدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تبدو الأكثر تأهيلاً اليوم للتفاوض بين الأطراف بسبب ما تملكه من رصيد سياسي ومعنوي وموارد مالية أيضاً، إلى تحويل مؤتمر قمة الرياض في آذار/مارس 2007 إلى قمة المبادرة العربية من أجل السلام. وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن حماستها لهذه المبادرة، وشككت في قدرتها على أن تكون أرضية للنقاش إذا لم يطرأ عليها تعديلات أولية، فإنها لم ترفضها. كما أن الأطراف الدولية المعنية الأُخرى شجعت عليها ووعدت تقديم الدعم لها. وإذا كانت الحاجة إلى الحشد الاستراتيجي ضد إيران هي الحافز لتبني واشنطن فكرة إطلاق مفاوضات سلام عربية إسرائيلية جديدة، فإن الأزمتين السياسية والمعنوية التي تعاني جراءهما إسرائيل بسبب الإحباط الذي أصابها، حكومة وأحزابا ورأيا عاماً، في إثر الفشل في حرب تموز/يوليو الأخيرة ضد حزب الله في الجنوب اللبناني، والإهانة التي تشعر بها نتيجة تكبدها هزيمة عسكرية كبيرة على يد من تنظر إليه كميليشيات أهلية صغيرة، تدفع الكثير من قادتها إلى مراجعة استراتيجيا الحل العسكري والتفكير في إمكان العودة إلى مقاربة سياسية للأوضاع الشرق الأوسطية.
وهكذا ليس من باب التفاؤل المبالغ فيه الإشارة إلى وجود مناخ في المنطقة عامة يدفع اليوم إلى التوجه نحو الحوار، والتشجيع على فتح جولة جديدة من مفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية، أو السورية – الإسرائيلية. بيد أن من الضروري أيضاً الإشارة، في الوقت نفسه، إلى أن هناك عوامل عديدة يمكن أن تقف حائلاً دون تحقيق التقدم المنشود. فإذا كانت الولايات المتحدة تسعى اليوم فعلاً لتجريب أسلوب المفاوضات من أجل التوصل إلى حلول أفضل للأزمة، فلا يمكنها قبول حلول للأزمات القائمة تتعارض مع مصالحها، في الوقت الذي لا تزال عاجزة عن إعادة تحديد هذه المصالح والتقليل من طموحاتها في ضوء النكسات الكبيرة التي تعرضت لها استراتيجيتها الشرق الأوسطية. فهي مستعدة لاتباع طريق الحوار في العراق، لكن لا من أجل ترك العراق للعراقيين أو للإيرانيين والعرب. ولا يختلف الأمر كثيراً عن ذلك بالنسبة إلى إسرائيل، إذ إنها مستعدة، مثل واشنطن، لتجريب طرائق أُخرى غير التي قادتها إلى تكبد هزيمة سياسية وعسكرية في حرب لبنان، لكن ذلك لن يساعد في التوصل إلى نتائج
مقبولة من الأطراف إذا لم تتخل إسرائيل مسبقا عن طموحاتها التوسعية والاستيطانية، وتقبل مبدأ التعايش مع دولة فلسطينية مستقلة. والمقصود أن المقاربة التفاوضية لم تصبح عند الأطراف القوية المسببة للأزمة، في واشنطن وتل أبيب، اختياراً نهائياً أو استراتيجياً يعكس تبدل أهداف الفاعلين أو التخلي عن بعضها، وإنما تبرز اليوم في إطار تجربة وسائلُخرى لتحقيق الأهداف المرسومة نفسها أو الدفاع عنها. ومن جهة أُخرى، يجب القول إن مصالح الأطراف العربية والإقليمية ليست متطابقة، أو لا تبدو كذلك، أو إنه يمكن التقريب بينها اليوم، وإن التنافس فيما بينها يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير منتظرة وسيئة بالنسبة إلى العرب جميعاً.( 5) ومن جهة ثالثة قد تتضارب أجندة المفاوضات العربية – الإسرائيلية، التي تبدو ذات وتيرة بطيئة بقدر ما تشتمل على ملفات معقدة ومتعددة، مع أجندة النظم التي تخضع لضغوط داخلية قوية، اقتصادية أو سياسية أو معنوية. وقد يؤدي البطء إلى تفجير الأوضاع أو تعقيدها، أو دفع البعض إلى تبني استراتيجيات منفردة للحصول على منافع موقتة تساعده في تأمين مخرج لبعض أزماته الضاغطة السريعة في إمكان واشنطن إيصال عملية التسوية السياسية العربية – الإسرائيلية إلى سلام ناجز لو قامت فعلاً بمراجعة جذرية لسياستها في الشرق الأوسط، وأقرت أن أصل الأزمة المستديمة، أو أحد مصادرها الرئيسية، هو استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان الإسرائيلي الزاحف، واقتنعت بعدم القدرة على حسم الصراع بالقوة وعلى حساب الطرف الأضعف، الفلسطيني والعربي. وفي هذه الحالة كانت ستضطر أيضاً إلى مراجعة سياستها تجاه إيران نفسها وتأخذ بنصائح كثير من الدول العربية والغربية التي تميل إلى إيجاد تسوية سياسية في ملف التقنية النووية الإيرانية أيضاً. والحال أن واشنطن تستخدم التلويح بتسوية عربية لتبرير استراتيجيا المواجهة مع إيران، سواء أكانت غاية هذه المواجهة ضرب إيران، أم محاصرتها بمساعدة الدول العربية. والمقصود أن التسوية العربية – الإسرائيلية لم تصبح بعد غاية بحد ذاتها ما دامت لم تندرج ضمن مقاربة شاملة مختلفة لأزمة المنطقة، ولا ترتبط باستراتيجيا شاملة لمواجهة هذه الأزمة تعكس المقاربة الجديدة.
إن ما يدفع إسرائيل إلى التطلع نحو بدء جولة مفاوضات جديدة مع العرب يمكن أن يصبح حافزاً على الإعداد لحرب جديدة. فلن يكون لإسرائيل مصلحة في العمل على إنهاء الصراع والتوصل إلى سلام مع العرب إلا في إطار مراجعة لأهدافها، تتخلى فيها عن طموحها إلى الاحتفاظ بالأراضي وتوسيع استيطانها كجزء من استراتيجيا مراكمة القوة والاحتفاظ بالتفوق في مواجهة التهديد، الذي تعتقد أنها تواجهه الآن أو في المستقبل، من جانب الدول العربية. فلا يصبح السلام رهاناً معقولاً لإسرائيل إلاّ في إطار التفكير في الاندماج في المنطقة والتحول إلى عضو كامل العضوية فيها، والمراهنة على هذا الاندماج في سبيل تحسين شروط حياة مواطنيها وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يعني تدمير الأسطورة التاريخية كلها التي بنيت عليها إسرائيل الحالية، والعمل على بناء إسرائيل جديدة مختلفة، هي فعلاً دولة لكل مواطنيها، بصرف النظر عن أصلهم ودينهم ومذهبهم، أي تطبيع حالة دولة إسرائيل، والقبول أن تكون دولة طبيعية وعادية مثلها مثل الدول الأُخرى. ومثل هذا التطور يحتاج إلى ثورة عميقة فكرية وأيديولوجية لا تظهر اليوم أي معالم واضحة لها في إسرائيل. ومن هنا يبدو لي أن المنطق الذي يوجه خيارات إسرائيل التفاوضية لا يزال كما هو، ولم يتغير منذ بداية المفاوضات في تسعينيات القرن الماضي، أعني التغطية على منطق الحرب المستمرة، واستخدام مبدأ المفاوضات ومساراتها لإضعاف الأطراف العربية ووضع أحدها في مواجهة الآخر، وبث التنافس فيما بينها في شأن تقديم التنازلات للحصول على المعاملة الأولى أو الأفضلية.
وعلى الصعيد الإقليمي تتضارب مصالح الحشد ضد إيران مع مصالح العمل على حل الأزمة العربية – الإسرائيلية. ولا يمكن أن تستقيم إلا إذا اعتُبرت إيران جزءاً من المعادلة الاستراتيجية الإقليمية. ومن غير الممكن أن تقدم الولايات المتحدة وإسرائيل لسورية حلاً مشرفاً في الجولان مكافأة لها على التحالف الطويل والدائم مع إيران، ما لم يتم التوصل مسبقاً إلى تفاهم أميركي – إيراني. وفي المقابل، ليس في إمكان دمشق، التي لديها كل الأسباب كي لا تثق بوعود الإدارة الأميركية، أن تتخلى عن علاقاتها القوية بإيران، وما تؤمن الأخيرة لها من تغطية استراتيجية وحماية سياسية ومعنوية، وتنضم إلى بقية الدول العربية الموسومة بالاعتدال، التي شاركت واشنطن في محاصرة النظام السوري وفرضت العزلة عليه بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية، رفيق الحريري، منذ عامين. هناك حالة واحدة يمكن أن يتحقق فيها خرق لمصلحة تسوية سورية – إسرائيلية قبل حدوث مثل هذه المراجعات للسياسات الكبرى، وهي حالة شبيهة بما جرى لمصر في كامب ديفيد، أعني أن تدرك إسرائيل أن اختياراتها سائرة نحو الضيق أكثر فأكثر مع تفجر المنطقة، وأن من مصلحتها اليوم البدء بتخفيف العبء العسكري والأمني. وفي هذه الحالة يمكن أن تفكر في أن اتفاقية سلام مع سورية بشروط معقولة، كتلك التي تحدثت عنها وثيقة جنيف، تشكل ثمناً مقبولاً للتخلص من مضاعفات القضية الفلسطينية والتحرر من كابوسها. بمعنى آخر إن استحالة التوصل إلى تسوية شاملة قد تكون حافز إسرائيل على البحث عن تسوية منفردة مع سورية. ولا يخفي كثيرون من المسؤولين الإسرائيليين رغبتهم هذه. وحدوث مثل هذا التفاهم السوري – الإسرائيلي يمكن أن يلغي المعوقات الأُخرى، بقدر ما يجعل التحالف السوري – الإيراني قليل الأهمية لدمشق، ويقربها من واشنطن ويفتح عليها خزائن دول الخليج جميعاً. لكن إسرائيل لا تبدو اليوم، أو على الأقل في المدى المنظور، في هذا الوارد، وهو ما عبر عنه فشلزيارة الأخيرة التي قام بها إبراهيم سليمان لإسرائيل.( 6) ثم إن موقف الإدارة الأميركية لا يزال غير واضح فيما يتعلق بتطوير العلاقات الجديدة مع دمشق، ولا تزال واشنطن تضغط على إسرائيل لمنعها من فتح باب المفاوضات الثنائية مع سورية. لكن ذلك الأفق مغلق أمام مثل هذا الاحتمال. وإدراك دمشق أهمية تذليل الممانعة الأميركية هو الذي يدفعها إلى تكرار التشديد على رغبتها العميقة في التفاهم مع واشنطن والعمل معها في العراق وفلسطين. وقد انعكس ذلك في الجو الإيجابي الذي ساد لقاء وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر شرم الشيخ في الثالث من أيار/مايو 2007 . وبالمثل من الواضح أن تشكيك دمشق في إمكان التوصل إلى اتفاق عن طريق الاصطفاف وراء المجموعة العربية والعمل خلف المبادرة الجماعية، هو الذي يدفعها إلى اختبار مساراتها الخاصة الجانبية التي تأمل من خلالها بتجاوز العقبة الأميركية، وإقناع إسرائيل بأن التسوية معها هي المفتاح لمواجهة جميع الأزمات والتحديات الأُخرى من حزب الله إلى “حماس” والأزمة الفلسطينية. لا يزال هناك عقد كثيرة يجب حلها في إسرائيل وفي سورية قبل إمكان التوصل إلى مثل هذا التفاهم وتحييد الموقفين الأميركي والعربي. وعلى الأرجح سيظل التجاذب بين الخيارين هو السائد فترة طويلة قبل أن تحسم الأطراف قرارها ما بين التسوية السلمية والعودة إلى الحرب. وبانتظار ذلك لن تتوقف سورية عن السعي لتذليل العقبات في وجه التسوية الثنائية، كما أن الولايات المتحدة لن تكف عن العمل لاجتذاب سورية بعيداً عن الاستراتيجيا الإيرانية، من خلال التلويح ببعض الحوافز، والضغط عليها في جوانب أُخرى، مثل موضوع المحكمة الدولية، واستمرارها في الضغط على إسرائيل لمنعها من الدخول في مفاوضات مع دمشق. ومن الممكن أيضاً، على الرغم مما نشر في الصحافة عن فشل مهمة إبراهيم سليمان في إسرائيل، وليس هناك ما يمنع، أن يتطور التفاهم بين تل أبيب ودمشق من وراء ظهر الولايات المتحدة، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً باستعادة الجولان، وكذلك من دون أن يغير طبيعة علاقة دمشق المعقدة والصعبة بواشنطن.
مفاوضات للمفاوضات
في المرحلة السابقة، ردت إسرائيل على شعار مؤتمر مدريد الذي تبناه العرب: “الأرض في مقابل السلام” بشعار سلام في مقابل سلام”، أي من دون إعادة الأراضي. وعملت 01 فعلى أساسه خلال أكثر من خمسة عشر عاماً من عمر” عملية السلام. واليوم هناك مخاوف مشروعة من أن تصبح المفاوضات، أو فتح المفاوضات بين الأطراف، هدفاً في ذاته، وأن تحوِّل إسرائيل شعار المفاوضات من أجل السلام إلى مفاوضات من أجل المفاوضات، أي في سبيل الحفاظ على الوضع القائم وضمان الأوضاع السياسية العربية في إطار من الهدوء والاستقرار. والقصد أننا يجب ألاّ نخلط بين نشوء المفاوضات وبين التوصل إلى تسويات عملية على الأرض. فمن الممكن تماماً، كما بيّنت تجربة العقود الماضية، ترتيب مسارات تفاوضية مستمرة وحية، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى تسويات، بل من دون أن يكون لدى الأطراف المتفاوضة أي رغبة حقيقية في التوصل إليها. بل إن الكثير من المفاوضات لا يخاض إلا للتغطية على غياب الحلول العملية، وأحياناً لإعداد الرأي العام للحروب المقبلة وإقناعه بحتميتها. ومن الواضح أن فكرة المفاوضات السياسية لم تدخل في ذهن القيادات الأميركية والإسرائيلية في الأشهر الماضية إلاّ في إطار
السعي لتقليص الخسائر الناجمة عن إخفاق الحلول العسكرية. وفي هذه الحالة من الممكن تماماً ألا تكون المفاوضات سوى حلقة من حلقات إدارة الأزمة الشرق الأوسطية بوسائل دبلوماسية، أي بأساليب أقل عنفاً، في انتظار تغييرات طارئة جديدة تنقذ الوضع أو تغير من تراتب القوى. ومما يزيد في هذا الاحتمال اعتقاد قيادات البلدين أن التناقضات القائمة وراء الأزمات الشرق الأوسطية عميقة ومستعصية على الحل. وهي تبدو كذلك فعلا لأن هذه القيادات لا تتصور حلاً يرتب على إسرائيل تنازلات والتزامات لا يمكن في نظرها إلا أن تخل بأمنها وتهدد مستقبلها، في الوقت الذي تدرك أيضاً أن من غير الممكن للأطراف العربية قبول توقيع سلام بالشروط الإسرائيلية. ولا يختلف الأمر كثيراً عن ذلك في العراق. فواشنطن تعتقد أن خروجها منه يعني تسليمه لإيران أو لجماعات القاعدة، وبالتالي تحويله إلى بؤرة وبالمثل، قد تحتاج الحكومات العربية إلى فتح مسار المفاوضات مع إسرائيل، لا في سبيل التوصل إلى اتفاق للإرهاب الدولي لا يمكن السيطرة عليها. نهائي، أو لاعتقادها أن شروط تحقيق مثل هذا الاتفاق أصبحت قائمة، وإنما في سبيل تمديد فترة السلام، أي سلام الأمر الواقع القائم اليوم على الأرض، وشراء صمت واشنطن أو تل أبيب، أو حتى الحصول على تأييدهما لسياساتها الإقليمية أو الداخلية. فبقدر ما يطمئن الحديث عن السلام مع إسرائيل العواصم الدولية، ويدلل على النيات الحسنة للحكومات العربية تجاه هذا الكيان، الذي يشكل أحد محاور السياسة الغربية الشرق الأوسطية الرئيسية، يغطي كذلك على عجز الدول العربية عن بناء استراتيجيا فعالة لمواجهة مشكلات احتلال الأرض والهيمنة الإسرائيلية الإقليمية. ومن هذه الناحية يهدف كثير من الأنظمة العربية في سعيه الحثيث للإبقاء على مسار التفاوض حياً، مهما يكن صورياً وشكلياً وفاقداً للنجاعة والفاعلية، إلى إخفاء عجزه عن مواجهة الواقع بصورة عملية، والتغطية
على فقدانه المبادرة الاستراتيجية، وانعدام خياراته جميعاً إزاء سياسة القوة وفرض الأمر الواقع الإسرائيلية. ومما فاقم هذا النزوع إلى التعويض عن العجز بالتشبث بالمفاوضات، ومن وراء ذلك لجوء العواصم العربية أكثر فأكثر إلى استخدام الدبلوماسية الموازية والرخيصة، التوافق الاستثنائي العميق الذي حدث في الأعوام الأخيرة، في ظللإدارة الجمهورية التي سيطر عليها المحافظون الجدد، بين الاستراتيجيتين الأميركية والإسرائيلية، سواء بسبب التطابق المتزايد في المصالح – تفكيك العالم العربي وتجريده من سبل القوة مصلحة مشتركة ومفيدة لواشنطن لتعزيز قبضتها على المنطقة، ولإسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني والقومي – أو بسبب تنامي قوة اللوبي الإسرائيلي وتغلغله في مؤسسات القرار الأميركية.
ومن هنا، هناك مجال للخوف من أن التوصل إلى حلول للاحتلال أو للأزمات التي يتخبط فيها الشرق الأوسط ما عاد المحرك الرئيسي للدبلوماسية المحلية أو العالمية، وحل محله هدف أقل طموحاً، لكن يبدو عملياً أكثر هو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، واستخدام تقنية المفاوضات لامتصاص التوترات، وتأمين إدارة النزاعات القائمة بوسائل أو بطرق أقل دموية وبتكاليف أرخص. ومن هنا فإن الجواب عن السؤال إذا كانت الأوضاع الراهنة تشجع على فتح حلقة جديدة من المفاوضات العربية – الإسرائيلية، والسورية – الإسرائيلية بصورة خاصة، هو أن المفاوضات لم تنقطع قط، وأنها ستتخذ أشكالاً أكثر تنظيماً ورسمية في المستقبل، لكن لا في سبيل التوصل إلى تسويات لا تزال غير ممكنة في أفق موازين القوى والمنظومات الفكرية والسياسية التي تسيطر على المنطقة، وإنما في سبيل التغطية على غياب هذه التسويات، ولملء الوقت الضائع. فهي نفسها تعبر عن الشكل الرث لسلام الشرق الأوسط، الوحيد الممكن والمتاح في الوقت الراهن، أعني التهدئة من دون حلول
المصادر
كان إبراهيم سليمان، الفيزيائي الأميركي من أصل سوري، قد عقد، بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس الإسرائيلية، ونقلته الصحافة العربية، في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2004 وآب/أغسطس 2005 ، سبعة اجتماعات عمل سرية مع ليئيل وأرونسون، اختتمت باجتماع أخير في تموز/يوليو 2006 خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. وعلى الرغم من حرص ليئيل وسليمان على التأكيد، خلال هذه الاجتماعات، أنهما لا يتفاوضان كممثلين عن حكومتيهما فإنهما أعلنا التوصل إلى مجموعة “تفاهمات”، سميت وثيقة جنيف، لإنهاء الصراع بين سورية وإسرائيل. وقد تضمنت هذه “التفاهمات” ما يلي: مبدأ انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 ، مع تحويل الجزء الأكبر من الأرض المحررة إلى محمية طبيعية؛ احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مياه بحيرة طبرية ونهر الأردن؛ تعهد سورية بوقف دعمها ل “حماس” و”حزب الله”، والابتعاد عن إيران والتعاون مع الدولة العبرية على محاربة “كل أنواع الإرهاب المحلي والدولي.” كما يوافق البلدان على تطبيع العلاقات بينهما في مختلف المجالات، وعلى إقامة مناطق مجردة من السلاح على جانبي الحدود بعد إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من الجولان.
لمزيد من التفصيلات، أنظر: رضوان زيادة، “السلام الداني: المفاوضات السورية – الإسرائيلية” (بيروت
مركز دراسات الوحدة العربية، 2005
بشأن تحليل أوسع عن سبب خسارة العرب معركة السلام، أنظر: برهان غليون، “العرب ومعركة السلام
بيروت، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2000
عن انهيار استراتيجيا الولايات المتحدة وتداعي أسس نظامها للشرق الأوسط، أنظر: برهان غليون، “ما بعد القومية والاستعمار”، 17 آذار/مارس 2007 ، في موقع “الجزيرة نت” في الإنترنت.
برز هذا التناقض بوضوح في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، إذ تضاربت المواقف الإيرانية والسورية. فبحسب2007 ، كانت طهران “غير راضية” عما تعتبره /5/ ما أكدت مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة “الحياة”، ارتجالاً” في السياسة السورية إزاء الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً اللقاء الأخير بين وزير
الخارجية السوري وليد المعلم، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.
بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، 15 نيسان/أبريل 2007 ، منيت زيارة سليمان الأخيرة لإسرائيل بفشل
ذريع. بل ربما يكون الكنيست استغل الزيارة كي يبعث برسالة إلى سورية عبر ضيفه من أصل سوري، إبراهيم سليمان، تقول إن الكنيست بأكثريته يرفض السلام مع دمشق. وفي لقاء للجنة الخارجية والأمنع الضيف السوري طلب النائب يسرائيل كاتس (ليكود)، رئيس لوبي الجولان، منه نقل رسالة إلى القيادة السورية فحواها أن الكنيست يرفض بأغلبيته الانسحاب من الجولان، وأن ” 61 عضو كنيست وقّعوا على العريضة ضد الانسحاب من الجولان، ومن المفضل أن يعرفوا ذلك في دمشق.” كذلك طلب كاتس من سليمان تحرير رسالة تهديد بأنه في حال شنت سورية حرباً على إسرائيل فإن كل أرض سورية تحتلها إسرائيل
ستبقى في يدها
برهان غليون
المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
Institute For Studies